'يسقط المطر...تموت الأميرة'


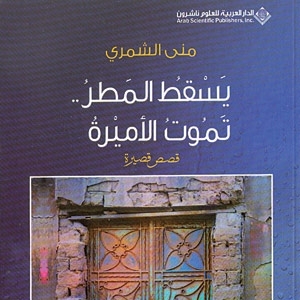


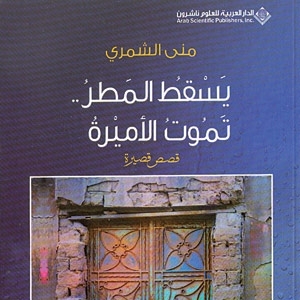

الكتاب: «يسقط المطر...تموت الأميرة»
الكاتبة: منى الشمري
«المدينة الغافية على البحر تفتح لي قميصها الأزرق القديم، وأنا كائن صغير طاعن في الحبّ، وكينونة الصور المغبشة التي تُبعث من حنين خامد، الحادث المرويّ المأساوي الذي سرق ذاكرتي حين هشّم جزءاً من جمجمتي يزفنّي إلى بواكير الأيام الأولى ببياض موحش يُغطّي العالم، يتسلّمني أبي من مستشفى العدان بذاكرتي المثقوبة، يأخذني إلى مدينتي في سيرتها الأولى، نسير حثيثاً إلى دروب الأمس لعلّني أتذكّر، يغمسُني لوناً في ريشة الحياة، أتساءل طوال الطريق: من أكون يا ترى؟ إغماءة حزن أم هذيان حمّى؟ خرافة أم كذبة بيضاء؟ كأنني لا أنتمي لرجل، ولم أُخلق يوماً من ضلعه الأعوج».
تختار الكاتبة الكويتية منى الشمري أن تبدأ مجموعتها القصصية الأولى «يسقط المطر... تموت الأميرة» (الدار العربية للعلوم ناشرون) بقصّة تبدو مقدمة أدبية للكتاب بعنوان «السير حثيثاً إلى أمس».
فهي لا تُشبه بقية قصص الرواية في تقنيتها السردية القصصية، وإنما تختصر في داخلها مُناخ المجموعة كاملة.
المكان الذي تؤنسنه القاصّة ليُصبح هو «البطل» أو الشخصية الرئيسية التي تجتمع حولها الشخصيات الأخرى.
راوية هذه القصص هي طفلة مشدودة دوماً للمكان الذي أحبّته وسكنته حتى سكنها ولم تفلح في أن يُغادرها وإن غادرته.
«الفحيحل» موجودة في معظم قصص مجموعة الشمري الجديدة. فالأحداث تتبدّل والشخصيات تتغيّر، إلاّ أنّ المكان يبقى وحده الفضاء الذي يؤطّر هذه القصص.
إلاّ أنّ الفحيحل، هذه المدينة التي تقع في جنوب الكويت والتي اشتُقّ اسمها من «الفحيل» أي النخيل، لا تحضر بصورتها الحالية وإنما بالصورة التي حفظتها ذاكرة الراوية الطفلة، فتظلّ هي المدينة الغافية على البحر والمُظلّلة لأسرار سكّانها الذين يتجلّون كشخصيات تعيش داخل جزيرتهم النائية التي لا يعرفها العالم ولا تعرف عن العالم شيئا.
هكذا نلتمس غرائبية المُناخ القصصي التي تُخفي في باطنها حقائق ذات بُعد إنساني واجتماعي، مع التشديد على البعد الجمالي الذي تُضفيه لغة الشمرّي وأسلوبها: «كانت البارحة ليلة مُظلمة، انقطعت فيها الكهرباء، وتجمدنا، حتى أشعل لنا أبي دوة الفحم، النعاس يتمدّد على جفوني حين ألقى إخوتي جبّات الكستناء ذات الزغب في جوف النار، رائحة شواء متأخرة، صوت حسيس النار، وحبّات الكستناء وهي تخلع صندوقها الخشبي فوق لظى الجمر لتبدو ثمرة ناضجة بداخله قد حان قطافها.
مشهد سرق النوم من عينيّ». (قصة «يسقط المطر تموت الأميرة»).
ومع أنّ القصّة القصيرة معروفة عادة بالإيجاز والاختصار، فإن القاصة تُمعن في التركيز على العنصر الوصفي الذي يُدخل القارئ في صميم حكايتها ويسمح له برسم الصورة البصرية للمكان وأهله. فيكثر المجاز في لغة الشمري وتكتظّ عباراتها بالصور البلاغية والاستعارات والتشابيه، ما يرتقي باللغة القصصية إلى مصاف اللغة الشعرية: «تخرج من الحمّام بكامل ثيابها، تبدو كشمس في ظهيرة حارّة لامعة مُشرقة، تدلف إلى غرفتها، مثل برعم تبّاع الشمس، أترك لعبتي القطنية في الحوش وأتبعها، يأسرني جمالها واختلافها الشاسع عن أمّي، أجلس أمامها، تُنعشني رائحة نظافتها المخلوطة بالمسك الأبيض والخمرية، تتأرجح عيناي في أسود شعرها الناعم حين تتركه على كتفها كليل موحش، تلفحه نسمات الهواء ليجفّ سريعاً، عطاء ربّاني، لا تُضاهيه جمالاً إلاّ تقاسيم وجهها، شفتاها لا يُفارقهما الديرم العنّابي، بارزتان كحبّات كرز حان قطافها، وعيناها الشهلتان كحبتي كستناء يزيدهما الكحل الأسود اتساعاً، فتغدو نظرتها ناعسة، وبشرتها بلون الحليب المخلوط بالعسل...» (من قصّة «كحل أسود... قلب أبيض»).
ورغم لغتها الإبداعية التي تُميّز هذه المجموعة، ارتأت منى الشمرّي أن تُدخل عليها اللغة المحكية النابعة من الأرض نفسها، ما يُكرّس واقعية القصّة وحضور المكان فيها: «وقبل الغروب يُعرّج بها إلى سوق مرزق، ليشترين من البائعات البدويات قطع السدو والأقط والبراقع والبخانق...» (ص39)، «في إحدى المرّات سمعت أحدهم يناديه: «يا كلب الحوطة». سألته فبدّد الحيرة: «يريدون أن أتركهم يسرقون السجائر ليُدخنوا ببلاش» (ص71).
أبطال قصصها لا يتشابهون. لكلّ واحد منهم صفاته وطبعه ومزاجه، إلاّ أنّ ذاكرة الراوية الطفلة تحفظهم جميعهم كأبطال خالدين، أبطال لا يشيخون ولا يموتون. بل إنهم يظلّون دوماً أحياء في ذاكرتها التي حفظتهم وحفظت المكان الذي جمعها معهم.
لعلّ حضور كتّاب القصّة القصيرة بات الأكثر انحساراً لمصلحة كتّاب الرواية والشعر، وخصوصاً في عالمنا العربي. وتظلّ بعض الأعمال بمثابة تجارب ضئيلة في مخزون أصحابها الكبير. من هنا يُمكننا أن نسأل ما إذا كانت منى الشمرّي ستُكمل في كتابة القصص القصيرة أم أنها ستتحوّل منها إلى عالم الرواية الأكثر شهرة وانتشاراً؟
شاركالأكثر قراءة

أخبار النجوم
دريد لحام يعود بشكل مفاجئ إلى سوريا... والجمهور...

أخبار النجوم
خالد سليم يثير قلق الجمهور: "حاسس إني هموت"

عائلات ملكية
الأميرة إيمان الصغيرة تخطف الأنظار بجمالها...

أخبار النجوم
أحمد حلمي يلخّص علاقته بمنى زكي في كلمتين (فيديو)

أخبار النجوم
هنا الزاهد تبكي على الهواء وتكشف أسراراً جديدة...
المجلة الالكترونية
العدد 1083 | آذار 2025


 إشترك
إشترك












