الشاعرة سوزان عليوان عن جديدها الشعري

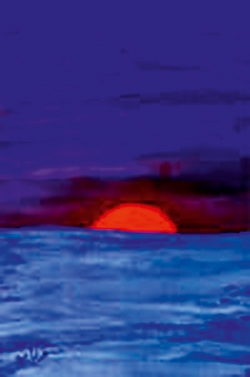



تتحدّث بلباقة شاعر... تكتب بقوّة نحّات... ترسم بروح طفل... إنها مزيج فني خاص نتج عن حياة شخصية خاصة أمضتها بين الأندلس التي وهبتها سحر الكلمة وباريس التي علّمتها أناقة التعبير والقاهرة التي أهدت إليها انسيابية اللغة وبيروت التي أورثتها روعة الخيال... فغدت سوزان عليوان شاعرة ورسّامة من طراز خاص لا يُمكن أن تكتشف خفاياها أو أن تفهم فلسفتها إلاّ عبر التوغّل في أعمالها التي لا تُشبه تجربة جيلها الشعرية ولا التشكيلية وإنما تُعبّر عن نزعة فردية تصبو نحو «الإنسانية» جمعاء... عن جديدها الشعري «كلّ الطرق تؤدّي إلى صلاح سالم» ورفضها فكرة بيع إصداراتها الشعرية أو إقامة معارض، فضلاً عن رأيها في بعض القضايا الشعرية والثقافية تحدّثنا مع سوزان عليوان، فكان لنا هذا الحوار.
- «كلّ الطرق تؤدّي إلى روما»، هي مقولة معروفة في معظم لغات العالم... إلاّ أنّك عدّلتها وقمت بتبديل مقاييس المكان كلّها بحيث باتت الطرق لديك تؤدّي إلى «صلاح سالم»... لماذا تختار شاعرة لبنانية في سنّك شارع «صلاح سالم» القاهري بالذات ليكون عنوان ديوانك الأخير؟
«كلّ الطرق تؤدّي إلى صلاح سالم» فيه إشارة واضحة إلى المكان وأيضاً إلى فكرة الحتمية أو التركيبة التي تؤكّد أن التعدّد يقود أخيراً إلى الأحادية. وأنا شخصياً مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بشارع صلاح سالم لكونه يُمثّل طريق مطار القاهرة الذي ظلّ لسنوات طويلة يُجسّد فكرة دخولي إلى المدينة وخروجي منها إلى العالم. فأنا نتيجة الحرب اللبنانية لم أعش في لبنان إذ أمضيت فترة طفولتي في مدينة ماربييا الإسبانية ومن ثمّ انتقلت إلى باريس وبعدها إلى القاهرة حيث عشت مدّة عشر سنوات قبل أن أعود إلى بيروت، النقطة الأولى والأخيرة في مشوار حياتي. ورغم اعتزازي بهويتي وجذوري ووطني إلاّ أنني لا أنكر فضل القاهرة عليّ كإنسانة وكشاعرة بالدرجة الأولى. فهي المدينة التي حولّتني من مجرّد طفلة تكتب خواطرها على الورق إلى شاعرة لها اسمها ومكانتها ومجموعاتها الشعرية. وبما أنّ القاهرة كانت بمثابة المحطّة الأساسية في حياتي، كان لا بدّ أن يبقى لكلّ شارع من شوارعها ولكلّ حيّ من أحيائها تأثيره البالغ في نفسي، من هنا كان لا بدّ لطريق مطار القاهرة المعروف ب«شارع صلاح سالم» أن يترك انطباعه الأكبر في نفسي والذي ترجمته من خلال ديواني الأخير.
- هل قصدت في اختيارك لهذا العنوان تحديداً أن يكون هناك تداخل بين الشارع «صلاح سالم» وشخصية «صلاح سالم» أحد الضبّاط الأحرار الذين شاركوا في ثورة 52 في مصر؟
في الواقع، انطلقت من اسم الشارع الذي يحمل إسم أحد الضبّاط الأحرار صلاح سالم، ومن ثمّ قرأت عن تفاصيل الشخصية وحيثياتها لأنني لم أرغب في اختيار هذا العنوان دون معرفة مُعمقّة بالشخص الذي أهدى اسمه للشارع. وبعد دراسة جادّة عن صلاح سالم وجدته شخصية تليق فعلاً بالشعر لأنه في الأساس إنسان مُحّب للفن والنزغ والشعر في شكل خاص. وبعد التدقيق في شخصيته وجدت بعض التفاصيل التي تُكرّس دوره في عالمي الفن والثقافة إلى حدّ أنه يستحّق أن يكون محوراً لدراسة فنية حقيقية. فهو رجل أثار جدلاً كبيراً في حياته الخاصة والعامّة. كما أحدث ضجة كبيرة يوم سافر إلى السودان ورقص شبه عارٍ مع القبائل بطريقة استعراضية غريبة. لذا وجدت أنّ إسم صلاح سالم- بعيداً عن السياسة- يُمثّل بحد ذاته حالة شعرية استفدت منها وحاولت أن أوظّفها في النص. وبالتأكيد لو أنني لم أجد شخصيته مناسبة شعرياً لغيّرت تلقائياً عنوان الديوان وفكرّت في عنوان آخر.
- تتميّز تجربة الجيل الشعري الحديث الذي تنتمين إليه بنزعة نحو الغوص داخل الذات وتفكيك الأشياء والتركيز على التفاصيل الصغيرة، رغم ذلك ذهبت لكتابة شعر يختلف بشكله ومضمونه عن تجربة جيلك إذ تسعين من خلال قصائدك إلى طرح سؤال الإنسان وهمومه وقضاياه بعيداً عن ذاتك الداخلية... فلماذا اخترت الإتجاه المعاكس لخط أترابك؟
«الأنا» هي الإنسان و«الذات» الواحدة هي «الإنسانية» جمعاء، وهذا ما أحرص على تأكيده من خلال كتاباتي إذ لا أضع فاصلاً بين الأنا الصغرى التي تعنيني و«الأنا» بمعناها الشامل أي تلك التي تُعبّر عن كل إنسان على وجه هذه الأرض. ومن وجهة نظري أعتقد أنّ الشعر لم يعد يتحملّ اليوم «الأنا» المفرطة بالصوت الداخلي والمتقوقعة على ذاتها وأنانيتها ونرجسيتها. فضلاً عن أنّ لحظة العالم لا تسمح للفرد بأن يكون معنيّاً بنفسه فقط لأننا نعيش اليوم زمناً بات فيه الإنسان أرخص شيء في هذا الوجود، وإذا لم يأتِ الشاعر ليُعيد اعتبار الإنسان نواجه كارثة حقيقية. وأنا لا أدّعي أنّ شعري يُعيد اعتبار الإنسان وإنما اعتبره محاولة من أجل ذلك. والمُلاحظ أنّ كلّ الآليات التي كانت تطرح سؤال الفرد أصبحت تتحدّث عن «المجموعة»، وكلّ مؤسسات العالم الصناعية والإستهلاكية حتى الدينية منها صارت تُخاطب الناس كجماعة. ولأنه لم يعد هناك أحد معني بالإنسان- الفرد، أقول إنّ رهان الفن اليوم سيعود ليُضيء على هذه النقطة وإن كان كجملة اعتراضية على ما يحدث.
- نفهم منك أنّك ضدّ نوعية الشعر الذي نقرأه اليوم لكونه لا يُركّز سوى على التفاصيل والتفاصيل الصغيرة أيضاً؟
أنا ضدّ القصيدة التي لا تحتوي سوى على التفاصيل لأنّ التفاصيل التي لا تقودنا نحو صورة أوسع لن تضيف شيئاً. فالعالم مُفكّك بما فيه الكفاية ولا يحتاج لمن يفكّكه أكثر. ففي الماضي كانت قوّة الفنان في تفكيك الأمور المعقدّة والشائكة وكان الشاعر من خلال التفاصيل التي يلجأ إليها يُقدّم مادة أو صورة جديدة لم يسبق للعالم أن رآها ولكن في وقتنا الحاضر هل ثمّة شيء مفكّك أكثر ممّا نعيشه اليوم؟ لذا أرى أنّه من الأجدر بي أن أقول أموراً ذات سقف أعلى من اليوميات ومن العابر والهامش وإنما من خلال أسلوب يبتعد كلّ البعد عن الخطابية التي أخشى وجودها في نصّي.
- هل يُمكن أن نُفسّر وجود مساحات الصمت التي تُعبّرين عنها من خلال البياض الذي يطغى على قصائدك نتيجة خوف من هذه الخطابية؟
تماماً، هذا بالإضافة إلى أنّني أحب أن يتنفّس النص بما فيه الكفاية وأن ترتاح عين القارئ أثناء قراءة قصائدي وأثناء سماعها أيضاً. لذلك أحرص دائماً على أن تكون مساحات الصمت موجودة في مجمل القصائد التي أكتبها. وأعتقد أنّ مساحات الصمت هذه ليست سوى جمل خفيّة تترك للقارئ حرّية استنتاجها وقراءتها وفهمها كما يُريد لأنّ القارئ في النهاية شريك أساسي في النص.
- من يقرأ قصائدك منذ بداية تجربتك الشعرية حتى اليوم يشعر أنك ترسمين القصيدة لا بل تنحتينها نحتاً. هل موهبتك في الرسم أثرّت على أسلوب كتابتك الشعرية أم أنها محاولة لتقديم شكل جديد في كتابة القصائد أشبه بالهايكو الياباني مثلاً؟
لا شك أنني متأثرة بالأدب الياباني كما أنني أحب كثيراً شعر الهايكو إلاّ أنني لا أكتبه أو أقلّده لأنّ الهايكو في النهاية عبارة عن شعر يتمتّع بمواصفات معينة وله قوانينه وأوزانه التي لا تتوفّر في قصائدي أو في أي قصيدة عربية أخرى. ولكن كل ما يمكن قوله في هذا الخصوص أنني شاعرة تستسيغ أسلوب التقطير على الثرثرة التي لا تستهويني على الإطلاق، فأنا من النوع الذي يحس بأن مهمّة الشاعر تكمن في قدرته على أن يُنقّي نصّه وليس في أن يكتبه فقط. إلى جانب ذلك أرفض في شكل قاطع أن يقوم الشاعر بصياغة جمل شعرية تعنيه شخصياً وإنما لا تعني الشعر أو القارئ. أمّا عملية نحت القصيدة كما ذكرت فهي جزء من رؤيتي للنص، ولا بدّ للشاعر أن تكون له رؤيته الخاصة لكلّ ما يكتبه لأنه لو لم تكن لديه رؤية صحيحة لأقرب الأشياء إليه فكيف سيتمكّن في المقابل من رؤية العالم والأشياء ومن ثمّ صياغتها بأسلوبه الخاص؟
- ولكن عملية نحت الجمل الشعرية تتطلّب قوة وصبراً من خلال التعديل المستمر وإعادة الصياغة وليس كما يحصل مع الشعراء الذين يفضلّون كتابة قصائدهم بعد الإنفعال الأول الذي ينتابهم... فهل أنت من الشعراء الذين يقسون على نفسهم في النقد من أجل تقديم عمل خالٍ من الشوائب؟
«الشاعر مسؤول عن الإنسانية»، هكذا يقول الشاعر الفرنسي الكبير رامبو. ولكن إذا لم يكن باستطاعة هذا الشعر أن ينقد نفسه وقصائده، هل سيتمكّن من أن يرى العالم وينقده؟ لذا أقول إن الشاعر يجب أن يكون أوّل ناقد لنفسه. وعلى المستوى الشخصي أرتأي عملية تشكيل الأشياء سواء في الرسم أو الشعر، لذلك يلاحظ قارئ شعر سوزان عليوان أن الصورة تُمثّل عنصراً محورياً في القصيدة لكونني أجد نفسي معنية مباشرة بالتشكيل عندما أمارس دوري كشاعرة. فالشعر من وجهة نظري يجب أن يُرى في مكانٍ ما وأن يُسمع أيضاً، فأنا أهتم بموسيقى النص إلى درجة كبيرة، ورغم أنني أكتب قصيدة النثر الخالية من الموسيقى إلاّ أنني أعتمد كثيراً على الإيقاع الداخلي، وإلاّ فما جدوى الشعر دون موسيقى؟
- كيف تفسرّين غياب العناوين الداخلية في معظم إصداراتك الشعرية؟
في إصداراتي الشعرية الثمانية كانت العناوين الداخلية موجودة باستثناء ديوان واحد كان مُرقماً، ولكن في آخر إصدارين استغنيت عن العناوين لأنه كان لدي تصوّر بأنّ النص الواحد يجب أن يكون نصاً مفتوحاً على بعضه من كل الجهات. فالقارئ يجب أن يشعر عند قراءة ديواني الأخير بأنه يمشي فعلاً على طريق صلاح سالم ووجود العناوين الداخلية قد تُزيل لديه هذا الإحساس، فما جدوى تقطيع شارع مركزي مثل شارع صلاح سالم؟ فأنا أعتبر «كلّ الطرق تؤدّي إلى صلاح سالم» بمثابة لوحة كبيرة مكوّنة من لوحات صغيرة، لذا ارتأيت إلغاء العناوين الداخلية لكونها لن تُضيف شيئاً إلى النص. وفي ديواني السابق «كراكيب الكلام» كانت هناك الفكرة نفسها، فالمطر يتساقط ويظلّ متواصلاً على طول الديوان، فما الفكرة من تقطيعه إذاً؟ والجدير ذكره أنّه في حال كان وجود العنوان الداخلي غير ضروري فهذا يعني أنه زائد عن الحاجة، وفي الشعر الحديث هناك إجماع على أنّ كل ما يفيض عن حاجة القصيدة سيفسدها ويفقدها الكثير من قيمتها. هذا بالإضافة إلى أنّ الإصدارات الشعرية الكلاسيكية كانت تحمل الكثير من القصائد التي تتنوّع في موضوعاتها إذ كان هناك قصيدة للوطن وأخرى للحبيبة أو الأم، لذا كانت العناوين الداخلية ضرورية من خلال توضيح فكرة النص وبالتالي مساعدة القارئ على اكتشاف موضوع القصيدة قبل المباشرة في قراءتها.
- لا يختلف إثنان على أنّ الواقع الشعري يعيش اليوم فترة من التردّي والإنحطاط. ألا تعتقدين أنّ قصيدة النثر أدّت إلى خلق جوّ من الإستسهال في الكتابة الشعرية لكونها لا تتطلب التقيّد بوزن أو قافية أو موسيقى معينة؟
رغم أنني بدأت كتابة الشعر من خلال قصيدة النثر إلاّ أنني كنت أتهّم في شكل مباشر قصيدة النثر على أساس أنها السبب في تراجع مستوى الشعر، ولكن بعد البحث والتدقيق وجدت أنّ السياق العام هو المُتهّم بدليل أن هناك شعراء مازالوا يكتبون التفعيلة والموزون وإنما في شكل رديء. فمن القادر اليوم على كتابة قصائد تُضاهي قصيدة واحدة للمتنبي أو أبو تمّام؟ الإشكالية ليست في قصيدة النثر، والرداءة موجودة في الرواية كما في الشعر وكذلك في مختلف المجالات والأدبية لأنّ الإستسهال والإستنساخ يؤديان حتماً إلى نتائج لا تُحمَد عقباها.
- هل يُمكن للشاعر أن يقتات في يومنا هذا من الشعر؟ وهل تعتبرين الشعر مهنتك أم هوايتك؟
الشعر ليس مهنتي ولا ينبغي أن يكون مهنة في الأصل. عندما كان الشعر مهنة كانت وظيفته معروفة: «المدح،الهجاء، الرثاء»... فكان الشعر حينها يلعب الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام اليوم، إذ كان الشاعر يدير الدفّة السياسية لصالح فئة ويهاجم فئة أخرى، والأرباح المادية التي تجنيها اليوم المحطات والصحف كانت تعود للشاعر الذي استطاع في فترة من الفترات أن يجعل من الشعر مهنته ومصدر رزقه الأساسي. أمّا اليوم وبعدما اختلف دور الشاعر لا أظن أن ثمّة من يتكّل على بيع دواوينه من أجل أن يعيش لأنّ الشعر ليس كالرواية ولا يحقّق الأرباح المادية التي تحقّقها الرواية أو غيرها من الفنون باستثناء بعض الشعراء الكبار أمثال نزار قباني ومحمود درويش. وأنا في الواقع لا أبيع دواويني بل أقوم بطباعتها على نفقتي الخاصة ومن ثم أوزعها على الأصدقاء مجاناً.
- لكن «كلّ الطرق تؤدي إلى صلاح سالم» في جناح «دار الجديد» شارك في معرض الكتاب العربي والدولي الأخير في بيروت؟
هذا صحيح، ولكن ما حصل أنّ إحدى صديقاتي المقربات أصرّت على أن تعرض 10 نسخ فقط من ديواني «كلّ الطرق تؤدّي إلى صلاح سالم» في جناحها الخاص في المعرض.
- «العالم لا يحتمل دمعة»... جملة شعرية معبرّة جداً في «كلّ الطرق تؤدّي إلى صلاح سالم»، ولكن كيف تبرّرين المعنى الذي تتضمنه هذه الجملة في ظلّ حياة نعيشها في عالم غارق في بحر من الدموع لا بل الدماء. ألا تجدين تناقضاً بين ما تقولينه في الشعر وما نعيشه في الواقع؟
في الجملة لعب على المعنين إذ يُمكن للقارئ أن يفهمها كما ذكرت في سؤالك أنّ العالم لا يحتمل دمعة في لحظة فرح أو ذروة، كما يُمكن أن تُفهم وكأنّ العالم لم يعد يحتمل دمعة واحدة من شدّة الدموع وكثرتها والتي يُمكن أن تؤدي إلى طوفان قد يجرفنا معه إلى مكان نجهله جميعاً. وفي سياق النصّ أرجّح المعنى الأخير. فالفكرة التي تطرحها الجملة تؤكّد أنّ هذه «الأنا» الذاتية التي تحدّثنا عنها في بداية الحوار أوهذه الدمعة الخاصة لم يعد لها مكان في عالم يغرق في بحر من الدماء وليس الدموع، فدمعتي أو دمعتك لن تهزّ العالم وهذا ما قصدته تحديدا في «العالم لا يحتمل دمعة».
- ما الذي تُريدين قوله من خلال وجه ذاك الطفل البريء الذي يُزين أغلفة إصداراتك الشعرية وكذلك رسومك الخاصة؟ وهل تعتمدينه دائماً ليصبح بالنسبة إلى سوزان عليوان ك«الحنظلة» بالنسبة إلى ناجي العلي؟
أتمنى أن أصل إلى مرحلة يُصبح فيها ذاك الوجه الذي أرسمه دائماً مرتبطاً باسمي إلى حدّ ارتباط رسم «الحنظلة» الكاريكاتوري باسم ناجي العلي. فأنا أرى أنّ وجه هذا الطفل هو جزء من روحي. وأعتقد أنّنا رغم النضج المُطالبين فيه ككتّاب وكبشر يبقى جانباً من الطفولة في داخلنا في حال فقدناها نكون قد فقدنا كلّ شيء. وكما تلاحظين وجه الطفل الذي أرسمه يكون مندهشاً وهذا بالتأكيد له دلالة على أن العالم كلّه ليس سوى دهشة بالنسبة إلينا. وهذا ينطبق على الشعر أيضاً لأنه لا معنى للشعر دون هذه الدهشة وإذا قلنا إنّ الشعر هو سؤال الإنسان فالسؤال يعني أيضاً الدهشة.
- ولكن رسومك أيضاً لا تحتوي سوى وجوه أطفال أو مشاهد طفولية. لماذا لا تختارين سوى الطفولة كـ «ثيمة» أساسية في لوحاتك؟
أنا متأثرة إلى حدّ بعيد بالفن التشكيلي الياباني وكذلك بالرسوم المتحركة اليابانية المعروفة، كما كان لرواية «الأمير الصغير» للكاتب الفرنسي أنطوان دو سانت اكسوبيري الأثر البالغ في نفسي. وأنا في طبيعة الحال أنتمي إلى الجيل الذي تربّى على هذه الأمور وتأثّر بها. هذا بالإضافة إلى أنّ الفشل السياسي والنهضوي في منطقتنا يخلق لديك شعوراً أنك طفلة كبيرة ولست قوّة فعّالة في العالم. نحن نعيش اليوم كعرب بنفسية المتلقّي لذا نشعر أننا أطفالاً كباراً لا بل نحيا كما الجنين بمعنى أننا نتلّقى كل شيء. وأشعر كلبنانية عربية في عام 2008 أنني إنسانة عاجزة عن فعل أي شيء. ولكن ما يمكنني قوله هو إنني حينما أفقد الدهشة أتوقف عن كتابة الشعر لأنّ الكلام سيولد ميتاً.
- بين سوزان عليوان الشاعرة والرسّامة... أين تجدين نفسك أكثر؟ وكيف تفضلّين التعبير عن نفسك بالريشة أم القلم؟
الرسم بالنسبة إلي مدخل للكتابة ولكن دهشة الرسم وفرحته أعلى من دهشة الشعر وفرحتها، وفي شكل خاص في السنوات الأخيرة. الشعر في الفترة الأخيرة صار يُسبب لي الكآبة وليس الإكتئاب بمعنى الحزن العميق. فاللغة تقودك دائماً لمواجهة الجرح وجهاً لوجه. أمّا الرسم فله فضاء آخر والألوان لها بهجة وفرحة أكبر. فأنا على المستوى الشخصي أفضّل الرسم رغم أنني لم آخذ حتى الآن قراراً في إقامة معارض ولكن على مستوى الطرح الفني أجد نفسي في الشعر طبعاً.
من «كلّ الطرق تؤدّي إلى صلاح سالم»:
الشجرة ذات الشعر الأحمر
الغابة التي غافلتنا وغابت
القصر المصلوب بين رصيفين كتقاطع
ثمّ كغروب مباغت
صرخة مالك الحزين
صلاح سالم
نظارة سوداء
كتفان بنجوم كثيرة
في صدأ نياشينه
ما يضيء خسائرنا
ما لم تقله الوردة
في وحلها تُدركه الدموع...
محطّة باصات مهترئة
مصباح لا يصلح مشنقة لحذائي
محبّتنا أودعتها النهر
ضعفي في نقطة
للمرسى أسبابه
النوارس للنسيان
مراكبنا من ورق
العالم لا يحتمل دمعة...
الأكثر قراءة

إطلالات المشاهير
تيا ديب ابنة نوال الزغبي تعتمد موضة الكروب توب...

إطلالات النجوم
أبرز فساتين سيدني سويني في عام 2025

إطلالات النجوم
آيس سبايس بإطلالة من الدانتيل الأبيض في عرض...

إطلالات النجوم
قصّة القلب تعود بقوة في إطلالات النجمات

إطلالات النجوم
الفساتين القصيرة… التوقيع الأبرز في إطلالات مي عمر
المجلة الالكترونية
العدد 1091 | تشرين الثاني 2025


 إشترك
إشترك












